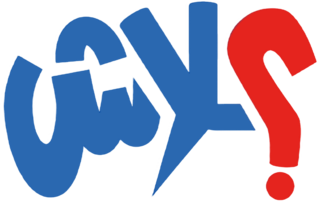ليبيا إلى أين؟
عندما أريد أن أستحضر صورة في مخيلتي لليبيا؛ لسبب من الأسباب لا تحضرني إلى صورة بقرة عجفاء يحلبونها من الشرق ويحلبونها من الغرب، ورغم كونها هزيلة وعجفاء لا تنتج حليبا يكفي جوعى أصحابها، إلا أن أيدي الحلابين لا تتوقف، وكلما ضعفت ووهنت، زادوا جرعات المنشطات التي لا تزيدها إلا ضعفا ووهنا، ثم يعودون لحلبها من ضرع جاف.
التوسع غير الطبيعي في الإنفاق لم يتوقف منذ اثنتي عشرة سنة، بل ازداد سوءا وتضخما وتفشيا، واليوم والبلاد على حافة الهاوية الاقتصادية، والعملة تنزف، والمدخرات تذوب، وآلاف الأسر تدخل طابور الفقر الطويل، لا زال الحكام في الشرق والغرب يتنافسون في من يبدد أكثر تحت شعار الإعمار، ولست معنيا كثيرا بمن بدأ، فالمهم أن كليهما مستمر.
قبل أسابيع أصدر مجلس النواب قرارا اعترف فيه بكل الديون التي ركبتها الحكومات الموازية على مدى السنوات الماضية عبر استدانة المليارات من البنوك المحلية، ديون بلا رقابة، بلا عقود واضحة، بلا نتيجة حقيقة وبلا مساءلة.
القرار يأمر مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط باقتطاع جزء من إيرادات النفط لسداد هذه الديون، أي أنهم باختصار يقولون لنا إننا –الليبيون- سندفع ثمن فسادهم بالتقسيط والتقطير على حساب آلامنا وآمالنا.
وفي نفس السياق، أصر المجلس على صرف 69 مليار دينار على مدار ثلاث سنوات لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، الصندوق الذي يرأسه بلقاسم ابن خليفة حفتر، الصندوق الذي أنفق المليارات على مشاريع أثبت بعضها فشله في أول اختبار، من جسور تتصدع، وطرق وشوارع غرقت في أمطار أسوأ موسم أمطار يمر على البلاد منذ سنوات، ومع ذلك يصرون.
وكأن البلاد تعيش رفاهية، ولم يبق لها إلا إنفاق المليارات سنويا على مشاريع معظمها إما فاشل أو موضع شبهة.
هذا المشهد المريع يطرح أسئلة لا مفر من مواجهتها.
الأول: إلى متى؟
إلى متى سيصبر الليبيون على جوع يطحنهم ودولار ينهش مدخراتهم وحكام يلهثون وراء سراب السيطرة الكاملة؟
هل يستطيع هذا التراكم الهائل من الغضب أن يتحول إلى انفجار شعبي يكتسح كل هذه الأجسام المتآكلة التي فقدت حتى شرعية الادعاء؟
زمن الثورات كما نعرفه ولى، و17 فبراير كان حدثا استثنائيا، اجتمعت حوله ظروف محلية وإقليمية ودولية يصعب تكرارها، والشارع الليبي اليوم منهك، مشغول بلقمة العيش، محاصر بخوف مبرر من سلطة تتعامل مع أي احتجاج كتمرد يستحق القمع المنقطع النظير.
السؤال الثاني: إلى أين؟
هل تيأس الزمرتان الحاكمتان في شرق البلاد وغربها من وهم السيطرة على كامل البلاد، فيرضيان بتقسيمها كحل وسط يضمن لكل طرف موارده ونفوذه؟
في حال القبول بهذه الفكرة، قد تبدأ المعركة الجديدة؛ أين الحدود؟ من يأخذ حقول الهلال النفطي وموانئه؟ من يسيطر على الهلال النفطي أصلا؟ من يرث التاج التجاري للموانئ الشرقية والغربية؟ ومن يتحكم في مياه النهر الصناعي؟ اتفاق التقسيم قد يكون نهاية مرحلة، لكنه سيكون بداية حروب أخرى، هذه المرة على الخرائط والموارد.
ليس هناك ما هو أكثر دموية من تقسيم لا يكتمل.
السؤال الثالث: هل من بصيص أمل؟ هل من بقعة ضوء في آخر النفق؟
تفاهمات باريس الأخيرة بين ممثلي معسكر الدبيبة ومعسكر حفتر قد تثير بعض الأمل لدى يائس متفائل، فهي لقاءات مغلقة، عقدت في قصر الأليزيه بعيدا عن عدسات الكاميرات وخطابات الكراهية المتبادلة، وجلس فيها الطرفان حول كعكة اسمها ليبيا ليجدا تسوية ترضيهما –وليست بالضرورة مرضية لنا- هل تثمر هذه التفاهمات توافقا على حد أدنى من التسوية؟ هل تفتح بابا لانتخابات تعيد الشرعية وتؤسس لمرحلة جديدة؟
اللافت أن هذه اللقاءات السرية جاءت قبل أيام قليلة من مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة، الرجل الذي كان يشكل، لمعسكري الشرق والغرب معا، خطرا حقيقيا في أي انتخابات نزيهة، فهو وإن اختلفنا معه إلا أنه كان يمتلك قاعدة شعبية لا يستهان بها، ويمثل رمزية اسم، وحاضنة قبلية تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومع غيابه، خفت ذلك الخطر المشترك، وصار الطرفان أقرب إلى التفاهم على اقتسام ما تبقى من كعكة النفط، بدل التنافس على من يأكلها كاملة.
السؤال الرابع، والأهم: أين نحن؟
في كل هذه السيناريوهات، أين الليبي العادي منها؟ هل هو جزء من المعادلة، أم مجرد رقم في حسابات الإنفاق، أو ضريبة تجبى باسم الدين العام، أو ناخب يستدعى ليعمد بحبر الانتخابات وليبارك تسوية أبرمها من سرقوا إرادته؟
في كل الاحتمالات، ثمة يقين واحد؛ البقرة ليست خالدة وستموت في النهاية، ليس لأنها عجفاء، بل لأن الحلابين لا يتركون لها ما تقوى به على الحياة، وعندما تسقط، سيسارع كل طرف إلى تحميل الآخر المسؤولية، بينما يفر كل منهم بمغنمه إلى حيث لا يصل صوت من سحقوا تحت أنقاضها.
ويبقى السؤال مفتوحا يبحث عن إجابة في أعماق كل منا إذا قررنا أن نعيش واقعنا ونبتعد عن تجاذبات الاستقطاب السياسي؛ هل ننتظر حتى تخر البقرة ساقطة على رؤوسنا، أم أن ثمة أفقا آخر لا نراه بعد؟
الجواب ليس في باريس، ولا في روما، ولا حتى في جنيف، الجواب، إن بقي منه شيء، يجب أن يبدأ من هنا.