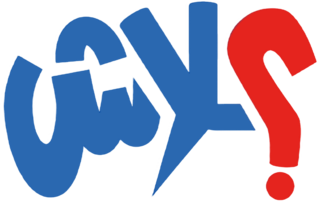علاش يحتفل الضحية بالجلاد ؟
ظهر مصطلح متلازمة ستوكهولم إلى الوجود منذ حوالي 50 عاما حين قام عدد من اللصوص بالسطو على مصرف في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد، وقاموا باحتجاز عدد من الموظفين وزبائن المصرف لمدة ستة أيام قبل أن ينتهي الحصار ويتم تحرير الرهائن.
وقد بدأ هذا المصطلح في التشكل على يد علماء نفس سويديين حين أبدى بعض الرهائن تعاطفا مع الخاطفين، وأظهروا أنهم كونوا مشاعر إيجابية تجاههم رغم المحنة التي مروا بها على يد هؤلاء الخاطفين لستة أيام متتالية.
ومنذ ذلك الحين بدأ مصطلح متلازمة ستوكهولم في الاستعمال لوصف المشاعر غير المنطقية التي يظهرها ضحايا التعذيب والاختطاف وسوء المعاملة تجاه من أساؤوا إليهم.
ويقول علماء النفس إن الشخص يمر بعدة مراحل قد تكون قصيرة أو طويلة للوصول إلى مرحلة الوقوع في أزمة التعاطف مع جلاده، حيث تبدأ هذه المراحل بتعرض الناس أو الشخص لصدمة مرعبة تجعله متأكدا من أنه مقبل على الموت لامحالة، وبعد نجاته من الموت المحقق ؛ يمر بمرحلة يقع فيها كليا تحت رحمة خاطفه، ويكون فيها عاجزا عن تلبية أبسط رغباته الأساسية مثل الأكل والشرب والنوم وحتى قضاء الحاجة، وهنا يتدخل الجلاد ليلبس ثوب المنقذ من خلال بعض الأعمال (الطيبة) كتقديم الطعام والشراب وغيره، وهو ما يحفز لدى الشخص العاجز شعورا بالامتنان تجاه من منحه الحياة.
ومع مرور الوقت واستمرار المحنة يتولد لدى بعض الضحايا شعور قوي أن الجلاد أو الخاطف في الحقيقة هو المنقذ، وهو الوحيد الذي يحول بينهم وبين الموت، وتبدأ عقولهم في رفض فكرة أن هذا الشخص هو المسؤول عن تعريضهم لهذا الموقف أصلا.
الدكتاتورية ومتلازمة ستوكهولم
إن المشاعر غير المنطقية التي يظهرها الرهينة المختطف أحيانا تجاه خاطفه يمكن أن تعمم لتشمل المشاعر غير المنطقية التي يظهرها الكثيرون في المجتمعات التي تقع رهينة بيد الدكتاتوريات، ويمكن من خلال نفس الآلية التي شرحت تعاطف رهائن المصرف في ستوكهولم أن نفسر تعاطف بعض الشعوب مع الأنظمة الدكتاتورية حتى بعد سقوطها.
فكما يوجد لدى الفرد غريزة الحياة وحب البقاء كذلك توجد لدى الشعوب غريزة للحفاظ على ديمومة الوطن كونه يمثل الأرض والعرض والشرف وغير ذلك من الشعارات التي تحقن في أدمغة الناس منذ الطفولة بغض النظر ما إذا كان هذا الوطن قد قدم لأبنائه حقهم في الحرية والكرامة والعيش بسعادة فوق أرضه أم لا.
ولأن الأنظمة الدكتاتورية عادة ما تعمر طويلا، فيحصل ارتباط وثيق في أذهان الكثيرين بين هذا النظام والوطن، فلا يرون إمكانية لبقاء الوطن واستمراره ورفاهيته إلا من خلال ما ينعم به الدكتاتور، تماما كما يرى الرهينة المختطف أن الحبل الذي يربطه بالحياة بيد خاطفه الذي يجود عليه بين الحين والآخر بما يسد رمقه ويحول بينه وبين الموت جوع وعطشا.
وهنا تتحول الرغبة عند الرهينة –سواء أكان شخصا أو شعبا- من الحرية التي يجدر أن تكون مطلب الجميع؛ إلى تحسين ظروف احتجازه، وكلما تحسنت هذه الظروف كلما زاد تعلقه بخاطفه أو دكتاتوره، حتى إذا ثار على الدكتاتور بعض الأباة نظر إليهم أبناء جلدتهم ورفاق محنتهم على أنهم بغاة وطلاب سلطة، وإذا نجح الثوار في إسقاط الدكتاتور دخل شركاؤهم في الوطن لمرحلة الحنين إلى الماضي والسعي الدؤوب لإعادته إذا ما سنحت لهم الفرصة للاختيار.
وعلى الرغم من أن كل الدراسات التي تناولت ظاهرة متلازمة ستوكهولم تناولتها من جانب سيكولوجي فردي يتعامل مع التغيرات السلوكية التي يظهرها أفراد لا مجموعات، إلا أن السلوكيات المجتمعية التي تظهرها المجتمعات التي وقعت تحت نير الاستبداد والدكتاتورية لفترات طويلة هي جديرة بالدراسة والاعتبار خاصة ما أظهرته بعض المجتمعات العربية من حنين إلى الماضي بعد سقوط أنظمة حكمتها لعقود طويلة بنظام لا يمكن وصفه إلا أنه دكتاتوري قمعي مستبد حتى وإن نجح في توفير بعض الأساسيات التي يعتبر توفيرها من واجبات أي نظام حاكم.
فيتبجح مثلا المصابون بالمتلازمة على غيرهم بأن الحياة في عهد الدكتاتور كانت أكثر أمنا واستقرارا، وجرائم القتل والاختطاف مثلا هي أقل مما يعيشه الناس الآن، والحقيقة أن القتل والاختطاف هي من سمات كل الأنظمة الدكتاتورية، إلا أنه في عهد الدكتاتور لا يطال إلا أعداء الدكتاتور، أم الآن فقد توسع ليشمل من كان آمنا منه فيما مصى، وبالتالي فإن من يرفض هذه الجرائم اليوم إنما يرفض احتمالية أن يقع هو ضحية لها أما إذا وقعت في خصومه فهو لا يعتبرها جرائم أصلا.
ويمعن المصابون بالمتلازمة في استرخاص أنفسهم فيتبجحون على خصومهم بنجاح طاغيتهم المحبوب في توفير القوت والزاد، ويرون أن هذا الثمن البخس هو جزاء وفاق لحريتهم التي اغتصبها في المقابل، وكأن غرضهم في الحياة هو الأكل والشرب، وكأن من جاد عليهم –منة منه وفضلا- بهذه الأساسيات قد ملك أعناقهم واستحق ولاءهم الأبدي.
الحقيقة بالتغيير لا بالتنوير
لا شك أن التعلق بالجلاد تحت أي صفة ولأي سبب هو تشوه سلوكي يجب تغييره، ولكن بأي طريقة؟ هل يتغير بالتعليم والتنوير والشرح؟ أم بالتغيير على الأرض والإثبات بالواقع أن ما أعطاه الدكتاتور للناس كان حقوقهم وأن ما منعه عنهم كانت حقوقا أحق وواجبات أوجب؟
لا يمكن إصلاح الخطأ بأخطاء أشنع وأفظع، ولا يمكن لعاقل أن ينكر أن ما جرته الثورات في البلاد العربية –وبلادنا مثال- هو في بعض زواياه أفظع مما قامت لأجل تغييره، وأن الناس تحرروا من دكتاتور ليقعوا ضحية آخرين، ومع هذا الواقع لا يليق وصم من يحن للدكتاتور الواحد بالوقوع تحت تأثير المتلازمة، واعتبار من يدافع عن نتيجة إسقاط الدكتاتور الواحد والوقوع تحت غيره بالتحرر والتنور؛ فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
إن التغيير المطلوب يكون بتأسيس نظام عادل يختاره الناس بملء إرادتهم ويملكون آليات محاسبته وتغييره، نظام يعطي الناس حقوقهم لأنها حقوقهم ولا يمن عليهم بها، نظام لا يخطف فيه الناس من بيوتهم لأنهم عبروا عن رفضهم له أو رفضهم لمن يقوده، نظام يعبر الناس تحت حكمه عن آرائهم بكل حرية وتحميهم القوانين التي تحكمهم وتحكم النظام.
يربط بعض الناس ممن يحن للدكتاتورية في أذهانهم بين الواقع الذي يعيشونه باسم الحرية وبين ما عاشوه سابقا فيختارون الماضي لأنهم كانوا فيه أكثر أمنا، ولو أمعنوا النظر لأدركوا أن ما يعيشونه اليوم لا يمت للحرية بصلة وأنه دكتاتورية من نوع آخر، ولو أمعنوا النظر مرة أخرى لرأوا أن ما يخلصهم ويخلصنا مما نعيشه الآن هو الحرية التي تقوم على القانون والعدل والتي يكون الأمن نتيجة لها، لا الأمن الصوري الذي يأتي في مقابل الحرية أيا كان من وفره.