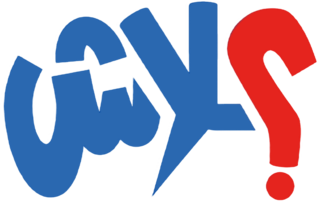كيف قُتلت الأخلاق في ليبيا ، وصار القاتل يمشي بيننا بطلاً؟
"الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، والإنسان إذا طال به التهميش، أصبح كالبهيمة؛ لا يهمه سوى الأكل، والشرب، والغريزة".
هذه كلمات قالها العلامة ابن خلدون قبل قرون، لكنها تكاد تكون التوصيف الأدق للحالة الليبية اليوم، وكأنه كان يعيش بيننا حين كتبها، فما نشهده ونعيشه ليس مجرد أزمة سياسية أو اقتصادية عابرة، بل هو انهيار قيمي وأخلاقي يضرب جذور المجتمع، تحولت فيه الإنسانية إلى سلعة رخيصة، وصار الموت مادة للسخرية والتشفي، والجريمة سببا للاحتفال، وأصبح الرقص في حفلات الدم السادية سلوكا يمارس جهارا نهارا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعد الناس فيه محتاجين حتى لأسماء مستعارة للاختباء خلفها، بل يكتب الراقصون والشامتون والمبررون والمهددون بأسمائهم وصورهم.
لم تعد جريمة قتل المهاجرين الأفارقة تستحق النعي، يكفي أن يروي أحدهم قصة عن قيام مهاجر برمي حجر على سيارة، حتى يتحول القاتل إلى بطل، وتصبح جثة الإنسان الذي ألقت به الأقدار إلى هذا البلد التعيس مرمية على قارعة الطريق مجرد درس لمن تسول له نفسه العبث بسيارات الليبيين.
التعليقات التي تلت حادثة الدهس المتعمد لمهاجر أفريقي كانت كافية لهز ضمير أمة، هتافات مؤيدة وداعمة، ودعوات لتكرار الفعل والإشادة بالفاعل، وتهنئة للقاتل بتطهيره للشارع من "الطفيليين"، واستحلال صريح لدم معصوم شرعا، وإن كان صاحبه لا يملك وضعا قانونيا يحميه حيا أو ميتا.
وفي مصراتة، لم يكتف قتلة الطبيبة الشابة بإنهاء حياتها، بل أضافوا إلى جريمتهم جريمة أخرى، وهي إهانة الذكاء الجمعي للمجتمع، فقدموا لنا مسرحية هزلية عن سحرها وغرقها، وبحثهم الدؤوب عن جثتها التي أهوى بها ساحر لعين في أعماق البحر فاختفت إلى الأبد، وصدقنا التبرير وطاش بنا الغضب، وسارع المعلقون إلى اتهام السحرة والمشعوذين، والمطالبة بطرد المهاجرين!، ولما تكشفت خيوط المأساة، وتبين أن أهل المغدورة هم من غدرها، بدأنا نبحث عن مبررات لنرضي تفوقنا الوهمي، فنحن لا نرتكب الجرائم بدون سبب، و(أكيد أبصر شن دارت).
المفارقة الساخرة أن المجتمع قبل الرواية الأولى بسهولة، لأنه يفضل أن يصدق أن السحر هو من قتلها، على أن يعترف بأن الأخلاق ماتت في بيوتنا قبل أن تموت الدكتورة، ونستمر نحن بعدها في البحث عن ذريعة أخلاقية لنغطي بها الوحشية التي أصبحت طابعا عاما.
وعندما اغتيلت المدونة الشابة الخنساء، كان من المفترض أن يمتلئ الفضاء بالتعازي والمواساة على الأقل، لكن الذي حدث كان صادما، وتحولت الفاجعة إلى مادة للتشفي والسخرية من القتيلة ومن زوجها، وتعليقات مثل "اللي ما يدير شي ما يجيه شي" و"وهاذي واحدة من الناشتات" و"الله لا يردها"، كشفت عن سرطان الحقد الذي ينخر في جسد المجتمع، فلم نعد نرى نجاح أي شخص في أي مجال إلا كإهانة شخصية لنا، ولم نعد نتحمل رؤية غيرنا يعيش حياة أفضل من حياتنا، فبدلا من أن نسعى للارتقاء، نفضل أن ينزل من هو في مستوى اقتصادي أعلى ليعيش معنا.
والأخطر من كل هذا هو تحول التهديد بالقتل والاغتيال والخطف والتعذيب، والتشفي في من تعرض لها؛ إلى رأي عادي يمكن التعبير عنه علنا، ولم يعد هناك أي حاجز بين الغضب من شخص والتحريض على تصفيته جسديا، نشطاء، سياسيون، صحفيون، مواطنون عاديون، يتحولون بين ليلة وضحاها إلى أهداف مشروعة لمجرد أنهم خالفوا رأي الأغلبية أو تجرأوا على قول كلمة حق، أو حتى كلمة باطل.
ابن خلدون عندما كتب ما كتب لم يكن يتنبأ، بل كان يقرأ سنن التاريخ، والليبي اليوم يعيش تحت وطأة ثلاث مقاهر؛ قهر السلطة وقهر الفقر وقهر العجز، سنوات من الحرب والانقسام والفساد جعلت المواطن يشعر بأنه لا يملك من حياته شيئا، وعندما يفقد الإنسان إحساسه بالكرامة والسيطرة على مصيره، يتحول إلى كائن أناني، عدواني، لا يهمه سوى بقاؤه اليومي.
الانهيار الأخلاقي الذي نراه اليوم ليس سبب الأزمة، بل هو نتيجة من نتائجها وعرض من أعراضها، إنه الصرخة المكتومة لمجتمع منهك، يائس، فقد الإيمان بكل شيء، لكن اليأس ليس مبررا للتخلي عن إنسانيتنا، والنزول إلى مستوى الوحوش لن يثبت أننا أقوياء، بل سيثبت أننا هزمنا من الداخل قبل أن نهزم من الخارج.
الطريق إلى الخلاص يبدأ بالاعتراف بأن المرض خطير، وأننا نحتاج إلى معالجة جذرية لا تبدأ من القمة، بل من القاعدة، تبدأ من بيوتنا، من مدارسنا، من مساجدنا، من وعينا اليومي بأن الحياة لا تستقيم بدون أخلاق، وأن الوطن لا يبنى بقلوب مليئة بالحقد والكراهية، وأن الله عز وجل عندما أراد أن يمدح محمدا صلى الله عليه وسلم قال له: "وإنك لعلى خلق عظيم".
ليبيا التي نريد لن تولد من رحم التعليقات الساخرة، ولا من التنمر على المخالف، ولا من ثقافة التبرير للجرائم، ولا من احتفالات الموت على منصات التواصل الاجتماعي، ليبيا الجديدة تحتاج إلى ثورة أخلاقية تعيد للضمير مكانته، وللإنسان قيمته، وقبل أن نصلح الدولة، علينا أن نصلح أنفسنا.