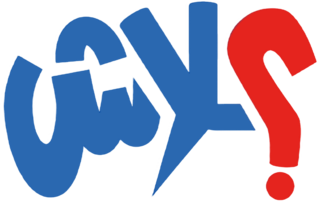المواطن المشتبه به: فلسفة الشك التي تُهيننا يوميًا!
يقول المتنبي
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه **** وصدق ما يعتاده من توهم
قد يحاكي هذا البيت حال السلطات الحاكمة في ليبيا قديما وحديثا، ويحاكي طريقة تعاملها مع المواطن، وتصنيفها له وتقييدها عليه، فلأنها سلطة محتالة، فهي تتعامل مع المواطن على أنه محتال وغشاش، تسيء به الظن ولا ترى فيه إلا لصا جاء ليسرقها، أو نصابا جاء ليراودها على ما عندها.
منذ أن فتحنا أعيننا في هذه البلاد ونحن نرى معاناة أبائنا وأمهاتنا من إذلال البيروقراطية، وتقييد الإجراءات، وكثرة المستندات بفائدة وبلاها، ولما كبرنا استشرفنا خيرا بأكذوبة الرقم الوطني الذي سيسهل الإجراءات ويخفف أعباء البيروقراطية علينا، لنفاجأ أن المستندات المطلوبة في كل معاملة حكومية لازالت كما هي بل زاد عليها الرقم الوطني حديث الإصدار، ولنكتشف أن لا شيء سيتغير ما لم تغير السلطة جلدها، وأن السلطة التي تنظر إلينا كمحتالين حتى نثبت لها العكس؛ لن تتعامل معنا بأي احترام، فنحن في نظرها لا نستحق الاحترام.
ذكرني هذا الواقع بمقال قرأته قديما لكاتب سعودي يشخص واقعا مشابها لواقعنا، ويحكي تجربته في أمريكا وبريطانيا، التي تفضح تناقضا مؤسسيا صارخا بين مبدأ "المواطن الجنتلمان" في الغرب مقابل "المواطن الحرامي" في عالمنا العربي.
فيحكي الرجل قصة طريفة ومحزنة في ذات الوقت لشخص عربي يعتقد أنه ذكي يخدع شركة الهاتف في أمريكا، ويسجل عندهم باسم (Walla Madfa) أي "والله ما ادفع"، ويتحدث الكاتب عن أن تصرف صديقه في الحقيقة لا يظهر ذكاءه وغباء الشركة الأمريكية، بل يجسد فلسفةً الثقة في المواطن كقاعدة، والتعامل مع المخادع كاستثناء تعالجه الأجهزة الأمنية لاحقا، نظام بني على افتراض أن الناس شرفاء، حتى يثبت العكس.
ثم يتحدث الرجل عن معاناته مع استخراج بديل شهادة في السعودية مقابل سهولته المذهلة في إنجلترا، فانقضت على ذهني صورة لا تختلف عن هذه في واقعنا الليبي اليوم، حيث تختزل علاقة المواطن بالدولة في شك متجذر، وإجراءات معقدة تعاملنا جميعا كمشتبه بهم حتى نثبت براءتنا.
ما وصفه المقال السعودي قبل سنوات، لا يزال ينبض بالحياة في تعاملاتنا اليومية مع السلطات المدنية والأمنية الليبية، بل ربما تفاقم، فعبثية المستندات وطواف الدوائر المغلقة ما زال مستمرا رغم إطلاقنا لمنظومة الرقم الوطني التي يفترض أن تغني عن كل المستندات لا أن تضاف إلى الدائرة المستندية المرهقة أصلا.
لماذا يحتاج تسجيل طفل في مدرسة إلى شهادة ميلاد حديثة الإصدار؟ أليست شهادة ميلاده الأصلية دليلا كافيا على وجوده؟ والأكثر سخرية، لماذا تطلب شهادات ميلاد الأب والأم؟ كأن المدرسة تحقق في نسب الطالب لا في قبوله.
هذا ليس تنظيرا، بل معاناة يومية ترهق كاهل المواطن وتضيع الوقت والجهد في متاهات لا طائل منها، والأمر يتكرر في كل مرافق الدولة.
ناهيك عن تناقض المؤسسات مع نفسها، فلو أردت استخراج جواز سفر لأرسلتك مصلحة الجوازات (التابعة لوزارة الداخلية) إلى مصلحة الأحوال المدنية (التابعة لوزارة الداخلية) لاستخراج عدد لا نهائي من المستندات، من نفس المنظومة التي يستعملها موظف الجوازات، ناهيك عن أن معظم هذه المستندات لا تمت لجواز السفر بأي صلة أصلا!
والأكثر إضحاكا وإبكاء أن يطلب منك إحضار صور شخصية، ثم لأنك محتال ولست محل ثقة، عليك أن توثقها من الخلف عند مختار المحلة! هذه الدائرة المفرغة من الإجراءات ليست إلا تعبيرا صارخا عن فلسفة "المواطن المحتال"، التي نعامل بها في بلادنا، وهي افتراض مسبق بأنك دجال ومحتال ويجب أن يوضع أمامك ألف حاجز، وعليك أن تثبت براءتك بقفز كل الحواجز.
الإهانة المقنّعة في طلب التوثيق، وطلبات الإفادات والكفالات والتعهدات التي ترفق بأبسط المعاملات ليست مجرد إجراءات روتينية، إنها رسالة واضحة من السلطة: "نحن لا نثق بك، أنت محتمل الاحتيال أو الكذب، قدم ضمانات ترهقك لإثبات صدقك"، هذه الرسالة تهين كرامة المواطن وتغذي لديه شعورا بالغربة داخل وطنه.
هذه الفلسفة الإدارية القائمة على الريبة المسبقة لا تعقد حياة المواطن فحسب، بل لها كلفة باهظة، فهي تشل الحركة وتعطل التنمية، فكم من المشاريع التجارية الصغيرة تعطل؟ وكم من الخدمات الأساسية تأخر؟ وكم من الوقت والموارد تهدر في مطاردة أوراق لا قيمة حقيقية لها؟ هذه البيروقراطية المعطلة هي عدو للازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أنها تكرس ثقافة الغش والخداع كرد فعل، فعندما يعامل الإنسان باستمرار كمجرم محتمل، قد يجد أن النظام المعقد يدفعه للالتفاف عليه، فيمارس الاحتيال فعليا.
ختاما: نحن لا ندعو هنا لتقليد النموذج الغربي دون مراعاة السياق والخصوصية، ولا ننكر الحاجة لبعض الضوابط الأمنية في ظروف معينة، لكننا نطالب بتغيير النموذج الذهني الذي تبنى عليه الإجراءات، ولنبدأ بافتراض الصدق، والتعامل مع المواطن كشريك جدير بالثقة حتى يثبت العكس، وليس العكس.
ولنبدأ أيضا بمراجعة كل الإجراءات والمستندات المطلوبة التي خيمت علينا لعقود، ولنقم بإلغاء ما لا ضرورة حقيقية عملية أو أمنية له، ولنركز على جوهر المعاملة.
ولنبدأ كذلك بإرساء مبدأ تكامل مؤسسات الدولة، وتطوير أنظمة معلومات موحدة وآمنة تتيح تبادل البيانات بين فروع الوزارة الواحدة وبين الوزارات المختلفة، لتجنب إرهاق المواطن بالحصول على مستند من "أ" لتقديمه لـ "ب" داخل نفس الكيان ولنبدأ قبل كل ذلك بالاحترام كأساس لمعاملة المواطن.
تلك القصة القديمة لـ "والله ما ادفع" في أمريكا، وقصة الشهادة الضائعة في السعودية، وواقعنا الليبي اليوم في طوابير الأحوال المدنية والجوازات والمدارس، كلها وجوه لنفس العملة، عملة الثقة المهدرة وافتراض السوء في شريك الوطن، وقد حان الوقت لقلب المعادلة، فبناء ليبيا المستقبل يبدأ ببناء ثقة متبادلة بين من يحكمون ومن يُحكمون، الثقة ليست ضعفا، بل استثمار في قدرة الدولة وكرامة المواطن وازدهار الوطن، ولنبدأ بتبسيط إجراءات تسجيل ذلك الطفل في المدرسة، فهو حي يرزق وهذا اسمه الحقيقي، ليس محتالا ولا نصابا، ولو كان كذلك لما حق لأحد أن يمنعه من التعليم.
وإلا فاكتبوا على أبواب مكاتبكم: "ادخلوا أيها المشتبه بهم" بدل "أهلاً بكم"، فما الفرق؟