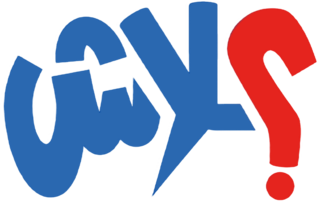نبو جيش ونبو شرطة!
نبو جيش ونبو شرطة؛ مقولة تتردد أصداؤها في ليبيا منذ سنة 2012، يكررها الكبار والصغار، الساسة وعوام الناس، الجميع يرددها على حد سواء دون تعيين واضح لأبعادها وحدودها والمأمول من وراء تحقيقها.
بعد ثورة 17 فبراير حلت على البلاد فوضى أمنية وعسكرية بكل معنى الكلمة، لجان أمنية وكتائبعسكرية وألوية وأجهزة وقوات متحركة وأخرى ساكنة، تعمل دون تحديد واضح لصلاحياتها، وتتداخل فيما بينها سواء في الصلاحيات أو في مناطق النفوذ، فتكون النتيجة الحتمية لهذا التداخل اشتباكات عادة ما تكون دامية، وعادة ما يدفع المواطن البسيط ثمنها من دمه أو ماله.
في ظل هذه الفوضى بدأ مصطلح (نبو جيش ونبو شرطة) في الظهور على السطح كأنه الحل السحري لمشاكلنا العميقة والبنيوية، فبمجرد أن نحل هذه اللجان والألوية والأجهزة، ونعيد تسميتها كمكونات عسكرية وشرطية ستحل كل المشاكل وستنعم البلاد والعباد بالأمن والأمان.
ومع ما في هذه الفكرة من تسطيح لمشاكل البلاد المتراكمة منذ عقود من الصناعة المبرمجة للفشل والفساد؛ إلا أنها لاقت رواجا شعبيا واسعا، وبدأت المظاهرات تخرج في عموم البلاد للمطالبة بحل كل الأجهزة التي تشكلت من بقايا الثوار والعودة إلى الجيش والشرطة، ولم تكن إلا مسألة وقت حتى تتلقف هذه الدعوات الشعبية تيارات سياسية لتجيرها لصالحها وتركب موجة المطالبات الشعبية لتظهر أمام الناس كأنها صوت الشعب.
الدعوات الشعبية التي أخذت زخما حزبيا، تلقفتها مؤسسات شبه عسكرية ساهمت في ثورة 17 فبراير ثم عادت لتجمع حولها شخصيات من النظام السابق ذات خلفيات أمنية وعسكرية لتشكل لنفسها ما يشبه الجيش، قوامه مقاتلون سابقون من الثوار، مقاتلون سابقون من قوات النظام السابق، وقوات شبه عسكرية ذات خلفيات قبلية وجهوية ومناطقية.
واستغلت هذه الجهات حالة الفراغ الأمني والعسكري في بعض مناطق البلاد، مع الظهور الواضح للجماعات المتطرفة التي أحكمت قبضتها فعليا على مدن ومناطق واسعة من البلاد، وبدأت هذه الجهات في شن حرب شاملة على كل من يخالف توجهاتها بحجة أن من يخالف توجهاتها متطرف وإرهابي، وبعد القضاء على الإرهابيين ومن وصموا بالإرهاب تجنيا؛ وسعت هذه الجهات حملتها لتشمل كل من يخالفها ولو بكلمة، فمن يرفض سيطرتها لا يريد الجيش والشرطة، وبالتالي لا يريد الأمن والأمان، وبالتالي فهو عدو للوطن وإرهابي.
في الطرف الآخر من البلاد؛ انقسم الناس بين مؤيد لما يحدث في الطرف الأول وبين رافض له، ودخل الطرفان في حرب قصيرة انتهت بسيطرة الطرف الرافض، ليوصم بعد هذه السيطرة أكثر من نصف البلاد من ناحية الحجم وأكثر من ثلاثة أرباع سكانها من الناحية البشرية بالإرهاب لنفس الحجج التي سبق ذكرها.
وبعد مفاوضات سياسية بين الطرفين تشكلت حكومة موحدة، فشكلت هذه الحكومة الموحدة (بالاسم فقط) أجهزة عسكرية بناء على البنية الموجودة منذ عهد النظام السابق، وأجهزة شرطية مبنية على نفس الأسس، ودخلت –ولو ظاهريا- في السياقات الرسمية، واختفت إلى حد كبير مظاهر التسلح العشوائية، واختفت معها سيارات الثوار وشعارات كتائبهم وملابسهم المختلفة، لتحل محلها سيارات الشرطة وأزياؤهم المعروفة.
وحتى هذا لم يشفع لهم عند أصحاب الحق الحصري في مصطلح الجيش والشرطة، فدخلت البلاد في حرب واسعة عام 2019 لتحريرها من الإرهاب مرة أخرى، وانتهت بتسوية سياسية (صورية أيضا) في 2020.
لنعد قليلا إلى ما قد يبدو أنه كان واجب التبيين منذ بداية المقال؛ ما المقصود بالجيش والشرطة؟
إذا بحثت عن تعريفات علمية ولغوية واصطلاحية لهذين اللفظين فإنك حتما ستجد العشرات من التعريفات، ولكن باختصار شديد وبجمع لمدلولات معظم التعريفات فإن الجيش والشرطة يجب أن يعملا كشبكة أمان للوطن والمواطن، يوفرا الحماية ويمنحا الشعور بالأمن والاطمئنان لكل المواطنين على حد سواء.
هل كان هذا حال المؤسستين التين تحملان هذا الاسم في عهد النظام السابق؟ لا، بل كان أبعد ما يكون عن ذلك، فقد كانتا أشبه بأدوات قمعية في يد السلطة، مهمتها الوحيدة حماية النظام، ولم يكن في شعاراتها وأهدافها وتصرفاتها على الأرض ما يوحي بأن للمواطن أي قيمة في حساباتها، هدفها الأول حماية النظام، وهدفها الثاني ترسيخ نظامها التراتبي وفرضه على الناس، فالضباط أعلى من الجنود ويتفاوتون بينهم بالرتب، والجنود والأفراد أعلى من عامة الشعب ومن حقهم قمعهم والسيطرة عليهم.
بعد ثورة السابع عشر من فبراير وبعد الفوضى التي لحقتها؛ هل عادت مؤسستا الجيش والشرطة لما كانتا عليه في عهد النظام السابق؟ أم لبستا الثوب الذي يجدر بهما أن تلبساه؟
هنا يختلف الجواب ويتنازعه رأيان؛ الأول يقول نعم، عادت هذه المؤسسات إلى ما كانت عليه سابقا، والثاني يقول إنها صارت أسوأ من ذي قبل، فهذه المجاميع المتناثرة من بقايا الثوار وبقايا كتائب القذافي ومن المقاتلين القبليين لا يجمعها إلا الولاء لصاحب الجيش وعائلته، فليس لها عقيدة أمنية وعسكرية واضحة، ولا تتبع أي قوانين ولا تلتزم بالإعلان الدستوري ولا سواه، إذا أردت أن تعيش فتجنب ما ينغص راحة الزعيم وأبنائه، أما إذا تعديت الخطوط الحمراء فسيتم تجريدك من كل حقوقك، ولن تكون محصنا بأي صفة وتحت أي ذريعة من قمع السلطات التي ناديت بها منذ 2012.
في الضفة الأخرى، نجحت المجموعات المسلحة والمليشيات الأيديولوجية والمناطقية والنفعية في تغيير جلدها، نزعت ثياب الثوار وارتدت ثيابا عسكرية وشرطية أكثر أناقة، وعادت لممارسة القمع التي كانت تمارسه سابقا، ولكن هذه المرة بصفة رسمية وبأرقام عسكرية، وتثقفت بثقافة جيش النظام السابق وشرطته فوضعت المواطن في قاعدة هرم الأهمية، فليس له حقوق ولا امتيازات ولا يملك حتى حق استخدام الطريق العام إلا إذا أذن له بذلك، وفي بواباتهم التي تكاد تنصب أمام بيوتنا، يعطون لأنفسهم الحق في تجريدك حتى من آدميتك، ولما لا؟ وأنت في عقيدتهم في قاع الهرم، ولا ينطقون صفتك التي يزدرونها إلا بتمطيط شفاههم بطريقة مشمئزة فأنت (مدني).
بعد هذا الطرح المختصر لماضينا وواقعنا، هل حقا (نبو جيش ونبو شرطة)؟
المطالبة الفعلية التي كان يجدر بالناس أن ينادوا بها منذ 2012 بل وحتى منذ أيام النظام السابق، هي تأسيس مؤسسة عسكرية محترفة تحمي حدود البلاد مواردها الطبيعية ومنابع مائها وحقول نفطها ومشاريعها الاستراتيجية وتشكل شبكة أمان لها عند الأزمات، ولا تتعدى على المواطن ولا تخوض حربا ضده لصالح فرد أو عائلة ثم لنسمها جيشا أو حتى عصابة، فدورها يحده القانون والدستور وممارستها منضبطة.
وكذلك تأسيس مؤسسة أمنية محترفة تحافظ على النظام والأمن العام وتحمي الأرواح والأعراض والأموال وتمنع الجرائم وتضبطها وتنظم المرور وتدير السجون وأعمال الدفاع المدني وشئون الجوازات والجنسية وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح؛ ثم لنسمها شرطة أو حتى مليشيا، فدورها يحده القانون والدستور وممارستها منضبطة.
أما إذا دفنا رؤوسنا في الرمال وبقينا على مطالباتنا العمياء (نبو جيش ونبو شرطة)؛ فعلى كل منا أن لا يغضب إذا انتهكت حقوقه أو اعتقل وسجن لأنه أزعج الزعيم، فالجهاز الذي يطالب به لا يحمي إلا الزعيم وعائلته، وعلى كل منا أن لا ينزعج عند سماع منبهات سيارة الشرطة خلفه في طريق مزدحمة وهي تناديه باسم سيارته (حول يمين يا تويوتا أو يا كيا) لتمر سيارة الشرطة أو الموكب الذي تحميه، فالجهاز الذي يطالب به يضعه في أسفل هرم الأهمية ولا يعترف له بأي حقوق.