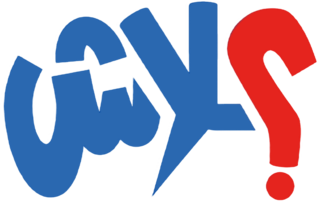600 مليون دولار في دولة بلا حارس "هل رُفع الحظر أم فُتحت الخزنة؟"
تقع سرت في قلب ليبيا، سواء من ناحية التاريخ أو من ناحية الجغرافيا، وما زالت حتى اليوم تدفع ثمن اسمها وموقعها، فمن العقيد الذي هي مسقط رأسه، إلى المشير الذي حولها مركزا لأحلامه، والمشير الذي رسم فيها خطه، وبينهم نسج أحد أكبر التنظيمات الإرهابية التي عرفها العالم فيها وكرا لنفسه مستفيدا من هشاشة وضعها وموضعها، ولكن هل تتذكرون سرت عام 2013؟
حين استيقظ العالم ذات يوم على خبر يختصر حالة بلد بأكمله، مجموعة مسلحة مجهولة تسيطر على سيارة نقل أموال كانت تحمل عشرات الملايين من الدولارات والدينارات، ثم تفشل الدولة في استردادها، قبل أن تؤسس بها داعش دولة على أنقاض الدولة، الصورة كانت أبلغ من أي كلام؛ ليبيا بثرواتها وفراغ سلطتها، أصبحت في عيون المجتمع الدولي غير آمنة لنقل الأموال، فالخطر صريح وواضح وقائم من أن تتحول أموال العالم إلى وقود للإرهاب، فجمدت التحويلات النقدية، ومنعت ليبيا من توريد الدولار ليحاصر المواطن الذي يطلب العملة الصعبة بين جشع الداخل ورفض الخارج.
اليوم، وبعد أكثر من عقد من الزمان، يعلن المصرف المركزي عن موافقة دولية لرفع هذا الحظر، ويؤكد تدفق 600 مليون دولار نقدي شهريا إلى البلاد، أرقام تبدو ضخمة ومبشرة ولكنها تثير أسئلة أكثر مما تنشر اطمئنانا؛ فما الذي تغير حقا ليغير العالم رأيه؟ هل اختفى تنظيم داعش حقا من المشهد الليبي؟ أم أن الخطر الأكبر لم يعد مسلحين يرتدون اللون الأسود، بل دواعش من نوع آخر؟ "دواعش المال العام" الذين ينتظرون هذه الدولارات بفارغ الصبر، كالضباع حول فريسة طال انتظارها.
يقولون إن العالم يعترف بتحسن الوضع الأمني، وهذا أمر وارد، فوفودهم تأتي وتذهب، وسفراؤهم يقطعون البلاد جيئة وذهابا، يرفسون البازين ويجمعون الترفاس، ولكن الأكيد أن للمواطن الليبي حسابا آخر، فخبرته المرة علمته أن الاعتراف الدولي قد يكون مجرد غطاء لصفقة أكبر تفتح الباب أمام الأموال، لكنها لا تغلق باب الفساد، فالفساد في ليبيا لم يعد ضيفا عابرا، بل أصبح بنية مستقرة وركنا من أركان الدولة، وتحولت الأزمة إلى "بيزنس" يمنع السلام، لأن إنهاءها بات أكثر كلفة على النخب المهيمنة من استمرارها، وهذه النخب تتقاسم السلطة مع السلاح ومع الميليشيات التي أصبحت جزءا من العملية السياسية، فكيف لموافقة دولية أن ترغم هؤلاء على تغيير قواعد لعبتهم المربحة؟
السؤال الجوهري ليس عن وصول الدولار، بل عن مساره بعد الوصول، هل سيتمكن مصرف ليبيا المركزي، وهو نفسه غارق في أزمة انقسام واستقطاب، من أن يكون سيد هذه العملية؟ أم أن مصيره أن يكون مجرد محطة عبور؟ تبدأ الرحلة بفروع المصرف المركزي، ثم تمر عبر شبكة معقدة من المصارف التجارية وشركات الصرافة، لتصل في النهاية إلى جيوب من يملكون القوة الحقيقية، القوة التي لا تكمن في المؤسسات الرسمية، بل في التحالفات غير المرئية بين السلطة والسلاح والمال.
لكن المشهد لا يكتمل دون الحديث عن تحول غريب في الاستراتيجية، فقد حول المصرف المركزي بعض مضاربي وتجار العملة الذين كانوا –ومازالوا- جزءا من المشكلة، إلى شركات صرافة رسمية بتراخيص، وأعطاهم الشرعية ليبيعوا العملة الصعبة بهامش ربح، وكأن الدولة تقول: "لا يمكننا القضاء عليكم، فلنتشارك في النهب".
لكن هل تملك الدولة أدوات الرقابة والسلطة لضمان التزام هؤلاء الشركاء الجدد؟ أم أن هذه خطوة لتلميع الواقع، بينما تظل القناة الرئيسية لتسريب العملة هي قناتهم نفسها؟ والخطر أن يدفع المواطن "الغلبان" ثمن هامش الربح مرتين؛ مرة كفرق سعر، ومرة كتضخم يلتهم ما تبقى من قيمة مدخراته.
ولماذا لا نفرح كمواطنين؟ لأننا نعرف أن المشاكل في بلادنا كثيرا ما تأتي متنكرة في صورة حلول، لأننا رأينا كيف أن مشهدنا السياسي لا يزال منقسما بين حكومتين ومجلسين وجيشين ونظامين قضائيين، وفي هذا الفضاء المشتت، لا نخشى على الدولار من مسلح في الصحراء بقدر ما نخشى عليه من مسؤول في مكتب مكيف، أو من قائد مليشيا يلبس البدلة العسكرية والبدلة الرسمية في نفس الوقت.
إنها المفارقة الليبية المستمرة، نطلب توافقا دوليا لإدخال العملة، بينما نفتقد الحد الأدنى من التوافق الداخلي لتوزيعها بعد وصولها، نحارب تنظيم داعش باسم الله ثم الوطن، بينما تستولي "دواعش" من نوع آخر على مقدرات نفس الوطن.
الموافقة الدولية على جلب الدولار قد تكون اعترافا بأن الخطر الإرهابي المباشر تراجع، ولكنها ليست ضمانة بأن الخطر الأكبر على مستقبل ليبيا – خطر نهب مؤسساتها وثرواتها – قد زال.
إن قصة الدولار في ليبيا ليست قصة أرقام وحوالات مالية فحسب، بل هي قصة قوة وسلطة وهشاشة نظام وانهيار دولة، 600 مليون دولار شهريا هي كمية هائلة من السيولة، لكنها في يد نظام ضعيف ومنقسم، تصبح سلاحا ذا حدين، إما أن تكون أداة لإنعاش الاقتصاد الحقيقي ورفع الغبن عن كاهل الناس، وإما أن تكون وقودا جديدا لصراعات النخب، تزيد الأسعار وتعمق الجراح، والخيار اليوم ليس بيد المجتمع الدولي الذي رفع الحظر، بل بيد الليبيين أنفسهم، فهم من يملكون القرار الحقيقي على الأرض، والسؤال الذي ينتظر الإجابة: هل من يملكون السلطة اليوم مستعدون لأن يكونوا حراسا لأموال الشعب، أم أنهم لا يزالون كما عهدناهم جزءا من المشكلة؟