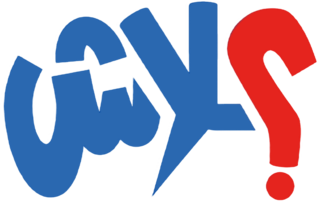في ليبيا القضاء يتحول إلى ساحة غنائم !
منذ ظهور الإنسان على هذه الأرض، ومنذ بداية تكون المجتمعات البشرية، ظهرت الحاجة إلى قوانين وضوابط تحكم سلوك هذه المجتمعات، وتصرفات أفرادها تجاه بعضهم بعضا، وفي البدايات كانت المجتمعات بسيطة، فكانت الضوابط بسيطة، ومع توسع المجتمعات ونشوء الدول والامبراطوريات؛ ظهرت الحاجة إلى قوانين أكثر دقة ووضوحا لتبين الحقوق والواجبات، وتعطي للدولة الحق في فرض سطوتها لتفرض الأمن والأمان.
وقديما كان الحاكم يمثل سلطة تكاد تكون إلهية، فهو المشرع والمنفذ، وهو القاضي والجلاد، ومع تطور المجتمعات مرة أخرى، حافظت بعضها على هذه المعادلة فرضيت بالاستبداد وسلمت مقاليد كل شيء للمستبد، فيما رفضت أخرى هذه المعادلة وأنشأت معادلة جديدة أسمتها الدولة الحديثة.
في قلب معادلة الدولة الحديثة يقع ثالوث متوازن، يقتسم فيما بين أركانه التشريع والتنفيذ والقضاء، وفي حين تتنازع السلطتان الأولى والثانية على شرعية التمثيل النيابي والسياسات الاقتصادية والمالية وغيرها، تمثل السلطة الثالثة ضمير الأمة وحارس دستورها.
هذا التوازن الدقيق لم يكن ترفا فكريا، بل هو الضامن الوحيد لتحول السلطة من أداة هيمنة إلى أداة خدمة، ولتحويل المواطن من رعية خاضعة إلى شريك في منظومة الدولة التي تدار بعقد اجتماعي، ويكاد يجمع الفقه الدستوري على مستوى العالم على أن (وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون)، بحيث لا قيمة لمبدأ فصل السلطات أو لإعلان الحقوق والحريات إلا بوجود رقابة قضائية مستقلة تضمن احترام هذه القيم والمبادئ، ولكن، ماذا يحدث حين تختل هذه المعادلة، وتتجاوز يد السياسة الخط الأحمر الفاصل لتمتد إلى حرم القضاء؟
الاستقلال القضائي يجب ألا يكون مفهوما نظريا يذكر في ديباجة الدستور ثم ينسى، إنه كيان حي يجب تأمينه على مستويين مترابطين؛ الاستقلال الشخصي للقاضي، والاستقلال الوظيفي للمؤسسة، فالأول يضمن حياد القاضي وحصانته، فيما يضمن الثاني عدم تدخل أي سلطة أخرى في مسار العدالة، وعدم تمرير قوانين على هوى الحكام أو على حساب المحكومين، ووفقا للفقه الدستوري، فإن هذا الاستقلال الوظيفي يعني، بالضرورة، عدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء، وأن أي تجاوز لهذا المبدأ لا يعد مجرد مخالفة إجرائية، بل هو اعتداء على جوهر دولة القانون ذاتها.
في السياق الليبي، جاء الإطار الدستوري الانتقالي – المتمثل في الإعلان الدستوري ثم الاتفاق السياسي المضمن به – ليكرس هذا المبدأ، فأقر مبدأ ثالوث السلطة كحجر زاوية لأي دولة حديثة، ومبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لعدم تغول أي فرع من فروع السلطة على فرع آخر، أو على الشعب، ولكن، ولأن الإعلان الدستوري –شأنه كشأن أي دستور- يحتاج إلى سلطات تؤمن به، وبعلويته على القوانين وعليها لتنفذه؛ وقعنا في فخ البدايات، مهووس حالم يرغب في أن يكون مستبدا، يترجم القوانين على هواه ويمضيها ليخدم مصالحه، وقوة عسكرية احتكرت بعض أفرع السلطة التنفيذية، تنازع هذا المهووس السلطة ولا تقر بسلطته عليها، لكنها رأت في بقاء هذا الحالم ضمانة لبقائها، فأمضت أهواءه لأنها جاءت على هواها، فكانت النتيجة تسرب الانقسام إلى السلطة القضائية بعد انقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصبحنا –كما نملك حكومتين ومجلسين تشريعيين- نملك محكمتين دستوريتين، إحداهما فصلت على مقاس المهووس الحالم، الذي سبق وأن استفرد لنفسه بحق سن القوانين فعمل عملا لم يسبق إليه؛ انتزع صفة إصدار الجريدة الرسمية من وزارة العدل وأعطاها لمكتبه، فأصبحت قوانين البلاد لا تصدر إلا من مربوعته.
والخلاصة القانونية الصارمة هنا تقول؛ (السلطة التي لا تنشئ لا تملك حق الإلغاء)، فمجلس النواب الحالي، بصفته انتقاليا وبالطريقة التي أقر بها سابقا بناء على تسوية سياسية لا عبر صندوق انتخابات، لم ينشئ المحكمة العليا ولا المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي لا يملك شرعيا حق المساس بها، وأي حديث عن تغيير أو استحداث أو إعادة نظر هو في حقيقته، تدخل في صلاحيات لا يملكها هذا المجلس ولا رئيسه الحالم.
هذه الصلاحيات، إن وجدت أساسا في دولة مستقرة، فهي من اختصاص سلطة تشريعية دائمة وكاملة السيادة، منتخبة عن طريق الشعب في انتخابات حرة مباشرة، وتعمل في ظل دستور دائم، أقره الشعب في استفتاء عام، وليس في ظل الترتيبات الهشة للمرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، ودفاعا عن إجراءات فردية اتخذها مهووس بالسلطة أجلسته الصدفة على سدة مجلس النواب؛ قد يطرح البعض حجة الإصلاح أو ضخ دماء جديدة أو تحرير القضاء من سطوة التشكيلات المسلحة كمبرر للتدخل الفج في السلطة القضائية ومحاولة تقسيمها، لكن التاريخ يعلمنا أن أخطر الاعتداءات على الحريات تأتي غالبا تحت شعارات براقة، وقد قال الأول (ألا قد أكلت يوم أكل الثور الأبيض).
إن اختراق استقلال القضاء هو انقلاب صامت على العقد الاجتماعي، يعيد البلاد إلى مربع الدولة العميقة حيث تخضع كل المؤسسات لهيمنة واحدة، إن حماية القضاء من هذه العواصف السياسية ليست ترفا، بل هي خط الدفاع الأخير للمواطن ضد تعسف السلطة، والضامن الوحيد لشرعية أي انتخابات قادمة، ولمصداقية أي مصالحة وطنية.
الاستقلال القضائي، في نهاية المطاف، ليس امتيازا ممنوحا للقضاة، بل هو حق أصيل للمواطنين أنفسهم، وهو الاستثمار الوحيد الذي يضمن أن يبقى للضعيف حجة، وللمظلوم ملجأ، وللدستور معنى يتجاوز الحبر الذي كتب به، والمساس بهذا الحق تحت أي ذريعة، هو ضربة في الصميم لمشروع الدولة ذاتها، وتحويل للمواطن من شريك في الحكم إلى رهينة في صراعات لا نهاية لها.
ومع إيماننا العميق أن المهووس الحالم لا يمكن أن يبلغ مبالغ المستبدين، فلا له قوتهم ولا هيبتهم ولا سطوتهم، وأن تصرفاته لا يمكن أن تمكنه مما يريد، ولن تفيده إلا أن تمد في بقائه المشؤوم لعام أو عدة أعوام، إلا أنه –إن أمضاها - ستخلق شرخا في جدار الدولة قد نحتاج إلى سنوات لإصلاحه، وما يحدث اليوم، تحت أي شعار براق، هو اختبار لصلابة فكرة الدولة نفسها في الوجدان الليبي، فالقضاء المستقل ليس هدية تمنح، ولا ميزة تسحب، بل هو الضمير الحي للأمة، وحارس الذاكرة الجماعية التي تمنع تحول البلاد إلى غابة.
المحاولات الراهنة، مهما ادعت النوايا الحسنة، تعيد رسم خريطة السلطة بخطوط متعرجة تخضع لهوى الحالمين بالاستبداد، لا لعدالة الدستور، والثمن الذي سيدفعه الليبيون، إن سكتوا، لن يكون مجرد تشويه لمرحلة انتقالية، بل خسارة الملاذ الأخير الذي يلوذ به الضعيف أمام جبروت المتسلطين، والتاريخ لا يرحم من يفرطون في العدل والحرية.