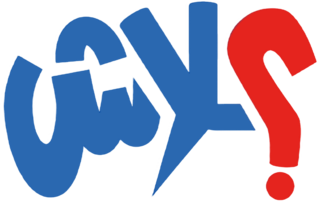علي الصلابي والمصالحة: هل تكفي “النية”؟
في لحظات التحول الكبرى، تختار الشعوب كيف تتعامل مع ماضيها: هل تفتحه بشجاعة ليُنظَّف ويُعالَج، أم تغلقه على عجل وتكتفي بعبارة مريحة من نوع “خلّونا نمشوا لقدّام”؟ في التاريخ الليبي، لدينا مثال مبكر على الخيار الثاني، حين رُوي عن الملك إدريس السنوسي قوله الشهير“حتحات على ما فات”، في سياق محاولة جمع الليبيين بعد عقود من الانقسام والصراعات القبلية والجهوية.
كان ذلك مفهوماً في لحظة تأسيس دولة ناشئة، بموارد محدودة، ونخب قليلة، وخشية حقيقية من أن تفجّر ملفات الماضي صراعات تعصف بكل شيء. لكن المشكلة لم تكن في النية، بل في النتيجة: الجراح لم تُشفَ، بل غُطّيت ، الثارات لم تُحلّ، بل جُمِّدت ، الألم لم يُعترف به، بل طُلِب من أصحابه أن ينسوه.
ثم جاء معمر القذافي، فلم يكتفِ بتجاهل الجراح القديمة، بل استخدمها أداة حكم. لعب على الانقسامات، وأعاد تشكيل التحالفات والعداوات بما يخدم بقاءه، فزاد الجرح تعفناً فوق تعفنه. وحين انفجرت ثورة فبراير، لم يخرج فقط غضب على نظام مستبد، بل خرج أيضاً تاريخ طويل من الأحقاد المؤجلة .
فجأة، تذكّرت قبائل ومناطق ثارات مضى عليها خمسون أو ستون عاماً، وكأن الزمن لم يمرّ، لأن الدولة لم تقم يوماً بدور الطبيب، بل بدور من يضع ضماداً فوق جرح ملتهب.
اليوم، ونحن نسمع دعوات متجددة للمصالحة، يبرز السؤال ذاته هل سنكرر منطق “حتحات على ما فات” مرة أخرى، لكن هذه المرة بعد حرب أهلية وانتهاكات أوسع وأعمق؟
في هذا السياق، يطرح الدكتور علي الصلابي نفسه صوتاً بارزاً في ملف المصالحة. لا يمكن إنكار حضوره وتأثيره، ولا تجاهل أنه يتحرك بدافع معلن نحو جمع الليبيين ، لكن النقد هنا لا يتعلق بالنوايا، بل بالتصور المطروح لطبيعة المصالحة نفسها.
التجربة السابقة التي ارتبط فيها اسم الدكتور الصلابي بحوارات وتفاهمات بين تيارات إسلامية والنظام السابق، قُدِّمت يومها كخطوة لخفض التوتر وفتح باب جديد. وقد يراها البعض نجاحاً جزئياً في إطارها الضيق، لكنها لم تمسّ جوهر المأساة الليبية ، لم تكن هناك حقيقة كاملة، ولا مساءلة، ولا إنصاف حقيقي لضحايا عقود من القمع ، كان أقرب إلى ترتيب سياسي–أمني منه إلى مسار عدالة ومصالحة شاملة.
القلق اليوم أن يُعاد إنتاج المنطق نفسه بصيغة جديدة: تسوية فوقية باسم الاستقرار، دون مسار حقيقي للعدالة. الفارق أن الدكتور الصلابي لم يعد مجرد وسيط خارجي أو داعية مبادرة مجتمعية، بل يُنظر إليه كأحد المؤثرين داخل العملية السياسية الجارية، وضمن الداعمين البارزين لمسار السلطة التنفيذية الحالية. وهذا يضعه في موقع شريك في المعادلة السياسية، لا مجرد واعظ أخلاقي من خارجها.
هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً ، هل يمكن لمن هو جزء من الترتيبات السياسية القائمة أن يقود مصالحة تُطال أيضاً مسؤوليات هذه الترتيبات نفسها؟ وهل تتحول المصالحة، في هذه الحالة، إلى غطاء لإعادة توزيع الشرعية بين النخب، بدل أن تكون إنصافاً للناس؟
جوهر الإشكال أن هناك خلطاً خطيراً بين الاعتراف والغفران ، الاعتراف واجب على من ارتكب الانتهاك، وهو شرط أخلاقي وقانوني لأي مسار جاد. أما الغفران، فهو حق شخصي خالص للضحية، لا يُنتزع منه باسم الوطن، ولا يُساوَم عليه مقابل وعود بالاستقرار. حين يُقال للناس ضمنياً “سامحوا لكي تستقر البلاد”، فإن العبء الأخلاقي يُنقل من الجاني إلى الضحية، وهذا انقلاب خطير في المعايير.
ليبيا لا ينقصها خطاب ديني أو اجتماعي يدعو للتسامح، بل ينقصها إطار واضح للحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات التي سمحت بالظلم أصلاً. بدون ذلك، سنعيد إنتاج دورة قديمة: تهدئة مؤقتة، صمت هش، ثم انفجار جديد حين تتغير موازين القوى.
الملك إدريس قال “حتحات على ما فات” فأسس دولة، لكنها حملت تحت جلدها أوجاعاً لم تُعالج. القذافي استثمر تلك الأوجاع وحوّلها إلى أداة سيطرة. واليوم، إن اكتفينا بشعار جديد للمصالحة لا يمر عبر العدالة، فقد نكون نؤسس لجولة قادمة من الألم، يدفع ثمنها جيل آخر.
المصالحة الحقيقية لا تخاف من الجرح، بل تفتحه لتنظيفه ، أما المصالحة التي تخاف من الحقيقة، فهي ليست سلاماً بل هدنة فوق بركان.