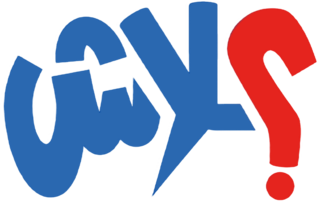نصف دولة ونصف مسرح: كيف صارت الإدارة في ليبيا عرضًا فرديًا؟
استمرار الوهم من "الزعيم الملهم" إلى "المؤثر الخارق": هوس الشخصنة وموت المؤسسة في ليبيا
ثمة مرض عضال ينخر في جسد الدولة الليبية، لكن أعراضه لا تظهر في انهيار البنية التحتية أو شح المواد الغذائية أو انهيار قيمة الدينار؛ إنه مرض أخطر، لأنه يصيب العقل الجمعي ويدمر فكرة المؤسسة من جذورها، إنه هوس شخصنة كل شيء.
والمشهد مألوف ومتكرر، جهاز حكومي ما، بعد سنوات من الجمود والخمول، يقوم بمشروع بسيط؛ ربما يصلح طريقا، أو ينظف شارعا، أو يجري عمليات جراحية، أو يوزع مساعدات غذائية في رمضان، وما أن يظهر الخبر حتى تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتمجيد الشخص المسؤول، وتنتشر صوره مع تعليقات تنسب العمل إليه وحده، وكأن المئات من المهندسين والإداريين والعمال الذين نفذوا المشروع ظلال بلا وجود، ويتحول المسؤول بين ليلة وضحاها إلى بطل ومنقذ وشخص خارق يستحق التكريم.
ولكن ماذا فعل هذا البطل بالتحديد؟ الإجابة المحزنة أنه قام بعمله الذي يتقاضى عليه راتبه، لقد قام بوظيفته، ولكن في ليبيا حيث الفشل هو القاعدة والسائد، تحول أداء الواجب إلى ضرب من ضروب البطولة الاستثنائية التي تستحق التمجيد، ونحن هنا لا نكافئ التميز، بل نحتفل بالحد الأدنى، نحن لا نطالب المؤسسة بأن تعمل، بل ننحني شكرا للشخص الذي تطوع بإدارتها للحظة.
هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، إنها امتداد طبيعي لثقافة سياسية تربى عليها الليبيون لأكثر من أربعة عقود، ثقافة اختزلت الدولة كلها في شخص واحد، جعلت من "الأخ القائد" محور الكون ومصدر كل خير، وكانت المؤسسات واجهة فارغة، والقرارات - كبيرها وصغيرها- تصدر من فرد واحد، حيث زرع النظام السابق في العقل الجمعي فكرة أن الإنجاز مرتبط بالقائد الملهم، وليس بالآلية المؤسسية المنظمة.
بعد سقوط النظام، سقطت صورته عن الجدران، لكن صورته في العقل بقيت، ولم نستبدل فكرة "القائد الأوحد" بفكرة "دولة المؤسسات"، بل استبدلنا قائدا واحدا بعشرات القادة الصغار، كل منهم يبني حول نفسه أسطورة شخصية، ويحاول أن يظهر كمخلص فرد في مشهد من الفوضى، فقد ورثنا عبادة الشخصية، ونقيناها فقط من شعاراتها القديمة.
في الماضي، كان القائد يحتاج إلى إعلام دولة ضخم لترويج صورته، أما اليوم في عصر الهيمنة غير المسبوقة لوسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام الليبي، صار الأمر في متناول أي مسؤول طموح، فتحولت هذه المنصات من أدوات اتصال إلى ساحات رئيسية لصناعة الرأي العام وتوجيه الوعي الجماعي.
لم يعد يحتاج المسؤول إلى فريق إعلامي معقد، إنما يكفيه صفحة جهازه أو مؤسسته على فيسبوك، ومصور واحد يتبعه كظله، يسجل له لحظة دخوله مكتبه في الصباح الباكر، ولحظة تفتيشه لمستودعات مؤسسته، ولحظة إلقائه توجيهاته المباشرة للعاملين، ولحظة تهديده للمخالفين، وتتحول هذه المقاطع إلى حملات علاقات عامة مكثفة، غالبا ما تكون ممولة، لتلميع صورة الفرد وكأنه رجل إدارة من طراز فريد، بينما المؤسسة التي يديرها قد تكون على حافة الانهيار.
على مستوى المسؤول نفسه، يصاب بنشوة البطل، ويبدأ بالتصديق هو أيضا للأسطورة التي يروج لها، فيتحول من ضابط شرطة أو وزير أو مدير مستشفى إلى "مؤثر" (Influencer) يسعى إلى تفاعلات وإعجابات المتابعين أكثر من سعيه إلى مؤشرات الأداء الحقيقية، ثم يتجرأ، فيتعدى صلاحياته، ويتدخل في ما لا يعنيه، مدفوعا بثقة زائفة بأن بصيرته الشخصية تفوق كل الأنظمة والقوانين، ويصبح الحساب الشخصي على "فيسبوك" أو "تليغرام" أهم من مكتبه الرسمي.
وعلى مستوى المؤسسة، يتم قتل روح العمل الجماعي، فيشعر الموظفون المخلصون، الذين كانوا عصب الإنجاز الحقيقي، بالإهانة والنسيان، وتذبل فيهم روح المبادرة، لأنهم يعلمون أن الفضل سينسب في النهاية لرأس الهرم وحده، وتتحول المؤسسة من كائن حي إلى خلفية صامتة في صور المسؤول، المؤسسة التي يجب أن تكون خالدة ومستمرة بمن فيها ومن بعدهم، تصير مرتبطة بأجل شخص معين وسمعته.
على مستوى المواطن، يتم تخديره بوهم الحلول السحرية، وبدلا من أن يطالب بشفافية المؤسسة ومحاسبتها، يركز كل رجائه على شخص يثق أنه سينقذه، وتتحول العملية السياسية من بناء دولة إلى انتظار مخلص، وهذا يفسد علاقة المواطن بالدولة، ويجعل الولاء للشخص بدلا من الوطن والمصلحة العامة، ويصبح التغيير مرهونا بتغيير الأشخاص، لا بإصلاح النظام.
يصف الكاتب الإيراني علي شريعتي حالة الشعوب التي تقع تحت تأثير الخطاب المضلل بـ"الاستغفال الاجتماعي"، ويقابلها بالمطالبة بـ"النباهة الاجتماعية"، وهي الوعي بدور الفرد في المجتمع وفهم السياق الحقيقي للأحداث، وهذه "النباهة" أو "الحصافة" كما سماها أحد الآباء الروحيين للثورة الأمريكية؛ توماس بين؛ هي ما نحتاجه اليوم.
علينا أن نستعيد "النباهة" أو "الحصافة" كي نميز بين الإنجاز المؤسسي الحقيقي، والعروض البهلوانية للبطولات الفردية المفتعلة، وأن نرفض أن نتحول إلى جمهور مذهول يصفق للمتوهم الذي يرقص على أنقاض الدولة.
الخطر الأكبر هو أن نستمر في مكافأة الوهم، فكلما ألهبنا مشاعرنا لشخص، كلما أخرنا بناء المؤسسة، وطالما بقيت المؤسسة غائبة، فمصير أي إنجاز، حقيقي أو ومسوق له، هو الفناء مع رحيل الشخص أو سقوط صورته، والدولة لا تبني بالعواطف والأبطال الخارقين، بل تبنيها الإجراءات الروتينية المملة، والمساءلة الصارمة، والأنظمة التي تستمر بمن فيها اليوم وبمن بعدهم.